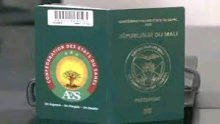قدّم المخرج والباحث المصري عمرو دوارة الذي رحل الخميس الماضي، واحداً من أبرز المشاريع التوثيقية في تاريخ المسرح العربي الحديث، فلم يكتفِ بعمله مخرجاً وناقداً فاعلاً في المشهد المسرحي، بل اختار لنفسه دوراً أكثر عمقاً واستمرارية، بجهده الممتد قرابة ثلاثة عقود، أنجز خلالها موسوعته الضخمة التي يمكن اعتبارها الأكثر اكتمالاً لتاريخ المسرح المصري الحديث.
لم يكن هذا المشروع ثمرة عملٍ مؤسسي كما يُفترض في عمل بهذا الحجم، بل إنّه نتاج إصرار شخصي بدأ منذ أن لاحظ دوارة غياب توثيق للمسرح المصري، على عكس السينما التي حظيت بعدد من الموسوعات. جمع الراحل مادته بنفسه، وتنقّل بين الأقاليم، ونقّب في أرشيفات الصحف والمجلات، واستعان بما تبقّى من صور الممثلين والمخرجين والملصقات القديمة. حتى إنّ بعض رحلاته للبحث عن معلومة أو صورة مفقودة كانت تستغرق أياماً طويلة، وربما دفعه البحث إلى السفر خارج مصر، كما فعل في تتبعه سيرة مؤسّسة مسرح أوبرا ملك التي اشتهرت في أربعينيات القرن الماضي واستقرّت آخر أيامها في العراق.
تضم موسوعة المسرح المصري المصوّرة (الهيئة العامة للكتاب، 2021)، أكثر من خمسة آلاف وخمسمئة عرض مسرحي، تغطي نحو قرنٍ ونصف القرن من تاريخ المسرح في مصر، من بداياته على يد يعقوب صنّوع في سبعينيات القرن التاسع عشر حتى منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ولا تقتصر الموسوعة على العروض الكبرى أو الفرق الرسمية، بل تمتد إلى ما كان يُعدّ هامشياً، مثل مسرح الصالات والمسرحيات المصوّرة للتلفزيون، وهما مجالان لم يُوثَّقا من قبل بهذه الدقة.
تضمّ موسوعته خمسة آلاف وخمسمئة عرض مسرحي خلال قرن ونصف الفرن
لم يكتب دوارة تاريخ العروض المسرحية فحسب، بل استعاد تاريخ العادات الفنية والاجتماعية المرتبطة بالمسرح نفسه: كيف نشأت الفرق الخاصة، وكيف تشكّل الجمهور، وكيف تبدّلت علاقة الدولة بالمسرح بين الحرية والوصاية، كما رصد تحوّلات الذائقة المسرحية من الستينيات المزدهرة إلى سبعينيات المسرح الاستهلاكي.
ولعل ما يميّز عمله عن غيره أنه اعتمد المنهج الميداني لا المكتبي؛ فالمعلومة عنده لا تُؤخذ من مراجع ثانوية، بل تُستعاد من مصادرها الأولى: شهادات الفنانين، وأرشيفات الفرق، وصور العروض القديمة التي أنقذ الكثير منها من الضياع.
لم يكتفِ عمرو دوارة بهذا المشروع، بل واصل العمل على مشاريع أخرى موازية، من بينها "موسوعة سيدات المسرح المصري"، كما أن له دراسة موسَّعة عن مسرح الصالات، أعاد فيهما الاعتبار لأسماء نسائية ومناطق منسية في تاريخ المسرح.
ومن خلال مؤلفاته وعمله التوثيقي، رسّخ دوارة تقليداً يقوم على الجمع بين الدقّة الأكاديمية وحسّ الفنان الذي عاش الخشبة عن قرب. فقد خبر الإخراج والنقد، وشارك في تنظيم مهرجانات وندوات، لكنه ظل يعتبر نفسه قبل كل شيء مؤرخاً يخشى ضياع ما تبقّى من الذاكرة المسرحية المصرية. وربما لم تحظَ موسوعته بعد بما تستحقه من اهتمام رسمي، رغم أنها إنجاز لا يقتصر على التوثيق فحسب، بل تضع أسس قاعدة معرفية تفيد كل باحث أو مخرج أو طالب مسرح سيجد في عمله، بلا شك، مرجعاً لا غنى عنه.