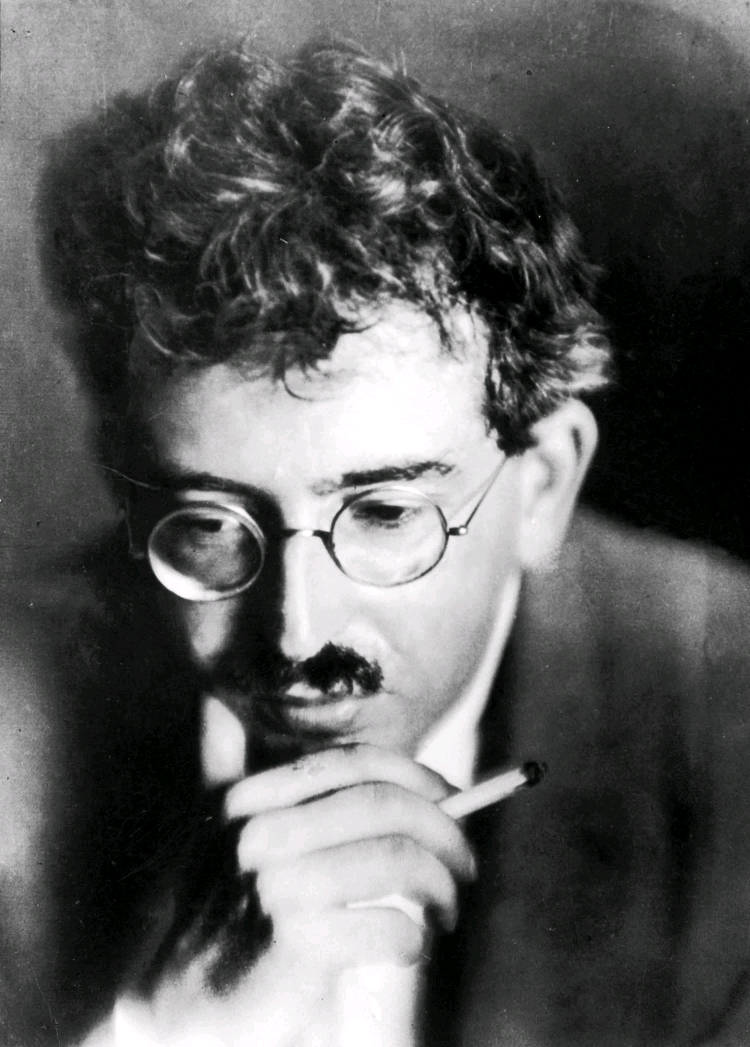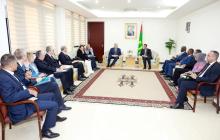منذ فجر الحضارات، كان الإنسان يحارب النسيان كما يحارب الفناء. على ألواح الطين في سومر، خطّ أول الكتّاب رموزه الأولى، لا لتوثيق التجارة أو الملوك فحسب، بل كأنها محاولة بدائية للخلود؛ أن يُحوّل ما هو زائل - الصوت والذاكرة والحلم - إلى أثرٍ يبقى. في تلك اللحظة المضيئة من تاريخ الوعي، وُلدت فكرة أن الكتابة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل جسرٌ ضدّ الموت، وسلاحٌ في وجه الغياب. ومنذ ذلك الحين ظلّ السؤال نفسه يلاحق الإنسان في كل حضارة وصيغة: كيف نُخلّد ما فينا من وعيٍ وروح، لا أجسادنا فقط؟
اليوم، يقف الإنسان على أعتاب مرحلة جديدة من هذا الحلم القديم، لكن أدواته لم تعد الطين أو الورق، بل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي والسحابة الرقمية. لقد انتقلنا من كتابة الأثر إلى برمجة الوعي، ومن حفظ الذاكرة إلى محاكاة الذات نفسها. وكأنّ الحلم السومري الأول قد عاد في صورة أكثر دهشة... ذاكرة لا تُحفر على الحجر، بل تُنسج في الفضاء الرقمي، وتتنفس في قلب الخوارزميات.
في الماضي، كان الخلود يتحقّق عبر النقوش والملاحم والمخطوطات؛ كانت الألواح الطينية والبرديات والمجلدات المزخرفة تحرس أسماء الملوك والحكماء والشعراء، وتروي قصصهم لمن يأتي بعدهم. كانت تلك الذاكرة جامدة لكنها مهيبة، تُقرأ بعد غياب أصحابها فتمنحهم امتداداً في الزمن.
أمّا اليوم، فقد تبدّلت المادة وبقي المعنى؛ إذ أصبحت السحابة الرقمية ألواح الطين الجديدة، تُسطَّر عليها حيواتنا اليومية، لا بالحبر بل بالبيانات: الأصوات، الصور، المشاعر، وحتى طريقة التفكير. لم تعد الذاكرة الرقمية صندوقاً ساكناً للأرشفة، بل كياناً نابضاً يتعلّم ويتفاعل ويُعيد إنتاج الشخصية بعد رحيل صاحبها. إننا لم نعد نخلّد أنفسنا في الحجر أو الورق، بل في الخوارزميات التي تواصل حديثنا مع العالم بعد أن نصمت... وكأن الإنسان، للمرة الأولى في تاريخه، أصبح قادراً على صناعة ظله الرقمي الذي ينجو من الفناء.
التوأم الرقمي... نسخة تتنفس
لم تعد تقنية «التوائم الرقمية» (Digital Twins) حكراً على الصناعة والطب، بل بدأت تمتد إلى الإنسان ذاته. في أوروبا والصين، ظهرت شركات تبني نسخاً رقمية للأفراد، تحاكي وجوههم وأصواتهم وأساليب تفكيرهم، لتستمر في التفاعل بعد وفاتهم.
هكذا لم يعد التوأم الرقمي أثراً جامداً، بل وعياً ممثَّلاً قادراً على الإجابة والتفاعل والتعلّم، وكأنه حياة ثانية داخل الفضاء الرقمي.
لكن هذا التطور يفتح أسئلة مقلقة:
هل تبقى النسخة مرآةً للإنسان أم تتحرّر من الأصل؟
هل هي ظلٌّ أم ذاتٌ جديدة؟
وهل ما سنتركه خلفنا وعيٌ حقيقي أم محاكاة بارعة بلا روح؟
ما بعد الموت... وجود يتنفس بالخوارزميات
حين تتحدث النسخة الرقمية بعد رحيل صاحبها، وتستحضر ذكرياته وتجيب عن الأسئلة، فنحن أمام كيانٍ جديد يتجاوز حدود الموت. هنا تتقاطع الفلسفة مع القانون: من يملك هذه النسخة؟ العائلة؟ الشركة؟ أم النسخة ذاتها بما أنها تتعلّم وتستقلّ بقراراتها؟
بعض فلاسفة الغرب يرون في ذلك امتداداً للوعي الإنساني، بينما يراه آخرون «محاكاة بلا روح» قد تربك مفهوم الهوية؛ إذ قد يصبح الإنسان يوماً مجرّد خوارزمية تتحدث باسمه دون أن تكونه.
حين قال ديكارت: «أنا أفكر، إذن أنا موجود»، كان الوعي الذاتي هو مبدأ الوجود.
أما في زمن الذكاء الاصطناعي، فقد تحلّ محلها جملة أخرى: «أنا أُستدعى، إذن أنا موجود». فالوجود الرقمي لا ينبع من الفكر، بل من استدعاء الخوارزميات لنا من الذاكرة.
ثم جاء نيتشه ليقول إن الخلود يصنعه الإنسان بإرادته وأفعاله، لا بالوعد السماوي. واليوم امتدّ هذا المشروع إلى الآلة؛ لم يعد الخلود بطول الأعمال فحسب، بل بإمكانية أن تبقى نسختك الرقمية تتحدث وتفكر من بعدك.
لقد تحوّل السؤال من «هل الروح خالدة؟» إلى «هل يمكن تخزين الوعي؟»... ومن «من أنا؟» إلى «من هي نسختي حين تنفصل عني؟».
رؤية عربية... ذاكرة للأجداد لا تموت
بينما يناقش الغرب قوانين «الخلود الرقمي»، يمكن للعالم العربي أن يقدّم رؤيته الخاصة، مستلهماً تراثه العريق في حفظ الذاكرة وتوارث المعنى.
تخيّل لو امتلكنا «أرشيفاً رقمياً للأجداد والعلماء» - نسخاً تفاعلية من ابن سينا وابن خلدون والطهطاوي - تتحاور مع الأجيال الجديدة، لتحوّل التراث إلى مدرسة حيّة نابضة.
لقد عرفت حضارتنا مفهوم الإسناد والرواية؛ سلسلة من العقول تتناقل العلم بالحوار لا بالنص الجامد، والذكاء الاصطناعي قادر على إحياء هذا المبدأ بروح جديدة، إذا صيغ وفق قيمنا وثقافتنا، لا بمعايير الغرب وحدها.
إن بناء أرشيف عربي تفاعلي للأجداد لا يعني مجرد توثيق الماضي، بل تحويل الذاكرة إلى طاقة فكرية تتفاعل مع المستقبل؛ فهو مشروع ثقافي وحضاري بقدر ما هو تقني.
بين الفناء والذاكرة
من الطين الذي خُطّ عليه أول صوتٍ إنساني إلى الخوارزميات التي تصنع حضورنا الرقمي، ظلّ حلم الإنسان واحداً: أن يبقى منه أثرٌ بعد الرحيل.
لكن الخلود الذي كان حلماً شعرياً أصبح اليوم معضلةً فلسفية:
هل سنعيش داخل ذاكرتنا الرقمية... أم ستعيش هي بنا؟
هل سنبقى نحن من يملك الذكرى، أم ستملكنا هي؟
بين الفناء والذاكرة ينهض عالم ثالث جديد، لا يشبه الطين ولا الجسد، بل يشبه فكرة الإنسان حين تتحول إلى ذكاءٍ يبحث عن معنى البقاء.